 من طرف AlJna 2011-10-23, 7:32 pm
من طرف AlJna 2011-10-23, 7:32 pm
مقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
أما
بعد .. فهذه دراسة عن موقف الإسلام من غير المسلمين، ويتضح بها احترام
الإسلام لسائر الأديان السماوية، ووجوب الإيمان بجميع الرسل والكتب
السابقة، كما يتضح بها موقف الإسلام من غير المسلمين في الحرب وفي السلم،
والمساواة بين المسلمين وغير المسلمين في سائر المعاملات، وسماحة الإسلام
مع غير المسلمين، والتي كان الناس بسببها يدخلون في دين الله أفواجاً، وأن
الإسلام هو دعوة كل الرسل. اسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير
والرشد والسداد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛؛ أ.د/
أحمد عمر هاشم
[b]احترام الإسلام لسائر الأديان السماوية:
احترم
الإسلام جميع الأديان السماوية، وأرسل الله تعالى سيدنا محمداً صلى الله
عليه وسلم خاتماً للأنبياء والمرسلين، ومصدقاً لجميع الرسل الذين كانوا
قبله، وأنزل الله تعالى على رسوله القرآن الكريم تبياناً لكل شيء ومصدقاً
لما بين يديه من الكتب ومهيمناً عليها وحارساً أمينا لها. وكان من عناصر
الإيمان: الإيمان بجميع الرسل السابقين وبجميع الكتب السماوية قال تعالى: {آمَنَ
الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ
آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } (سورة البقرة الآية 285)
بل إن إيمان المؤمن لا يكون صحيحاً إلا إذا آمن بجميع الأنبياء السابقين،
وآمن بما أنزل الله تعالى عليهم من الكتب السماوية الصحيحة، قال تعالى: {قُولُواْ
آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا
أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ
نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (سورة
البقرة الآية 136) ومادام كل مسلم مأموراً أن يؤمن بجميع
الرسل السابقين وبجميع الكتب السماوية، فلا يكون لديه تعصب، ولا كراهية
لدين آخر أو نبي أو رسول، ولا كراهية ولا حقد على أحد من أتباع الأديان
الأخرى. ووضع القرآن لأتباعه ما قضته الإرادة الإلهية منذ الأزل، من اختلاف
الناس في عقائدهم وأجناسهم وألوانهم، وذلك لحكمة يعلمها الحكيم الخبير.
قال سبحانه: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ
النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ "118" إِلاَّ
مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لأَمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ } (سورة هود،
الآيتان: 118، 119) وقال جل شأنه: {وَلَوْ
شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ
تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ } (سورة يونس الآية 99) ولا يحجر الإسلام على أحد، ولا يكره أحدا على الدخول في عقيدته، قال الله تعالى: {لاَ
إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
(سورة البقرة الآية 256)
موقف الإسلام من غير المسلمين:
من
المعلوم أن الإسلام هو دين السلام، لا يأمر بالحرب إلا في الضرورة القصوى
التي تستدعي الدفاع والجهاد في سبيل الله، ومع مشروعية الجهاد في سبيل الله
دفاعاً عن الدين والعقيدة والأرض والعرض، فإن الحرب في الإسلام لها حدود
وضوابط وللمسلمين أخلاقهم التي يتخلقون بها حتى في حربهم مع من يحاربهم من
غير المسلمين، فأمر الإسلام بالحفاظ على أموال الغير، وبترك الرهبان في
صوامعهم دون التعرض لهم، ونهى الإسلام عن الخيانة والغدر والغلول، كما نهى
عن التمثيل بالقتلى، وعن قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وعن حرق النخيل
والزروع، وقطع الأشجار المثمرة، وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أسامة
بن زيد عندما وجهه إلى الشام بالوفاء بالعهد وعدم الغدر أو التمثيل، وعاهد
خالد بن الوليد أهل الحيرة ألا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة ولا قصراً، ولا
يمنعهم من أن يدقوا نواقيسهم أو أن يخرجوا صلبانهم في أيام أعيادهم. وكان
عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحيماً بغير المسلمين من أهل الكتاب، وكان ينصح
سعد بن أبي وقاص ـ عندما أرسله في حرب الفرس ـ بأن يكون حربه بعيداً عن
أهل الذمة، وأوصاه ألا يأخذ منهم شيئاً لأن لهم ذمة وعهداً، كما أعطى عمر
رضي الله عنه أهل إيلياء أماناً على أموالهم وكنائسهم وصلبانهم وحذر من هدم
كنائسهم، وأمر الإسلام بحسن معاملة الأسرى وإطعامهم قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا } (سورة الإنسان الآية
بينما يعامل غير المسلمين أسرى المسلمين معاملة سيئة، فقد يقتلونهم وقد
يسترقونهم أو يكلفونهم أشق الأعباء والأعمال، فإن أسرى غزوة بدر الكبرى
عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم خير معاملة، فوزعهم على الصحابة وأمرهم أن
يحسنوا إليهم، فكانوا يؤثرونهم على أنفسهم في الطعام وفي الغذاء، ولما
استشار أصحابه في شأن أسرى بدر، وأشار البعض بقتلهم، وأشار الآخرون
بالفداء، وافق على الفداء، وجعل فداء الذين يكتبون منهم أن يعلم كل واحد
منهم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وكان هذا أول إجراء لمحو
الأمية. ولم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمثل بأحد من أعدائه في
الحروب مهما كان أمره، ولما أشير عليه أن يمثل بسهيل بن عمرو لأنه كان يحرص
على حرب المسلمين وعلى قتالهم فأشير عليه أن ينزع ثنيتيه السفليين حتى لا
يستطيع الخطابة بعد ذلك لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بل رفض
قائلاً: لا أمثل به فيمثل الله بي، وإن كنت نبياً وعندما حقق الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أمنيته بفتح مكة المكرمة ودخلها فاتحاً منتصراً ظافراً قال لقريش: "ما
تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم، فقال صلى الله
عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم"
ومن توجيهات الإسلام للمسلمين في الحرب:
1. أن يكون القتال في سبيل الله. 2. أن يكون القتال لمن يقاتلون المسلمين. 3. عدم الاعتداء، قال الله تعالى: {وَقَاتِلُواْ
فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ
اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ } (سورة البقرة الآية 190)
فالذين يعتدون على المسلمين ويقاتلونهم أمر المسلمون أن يقاتلوهم، ولكنه
قتال عادل بمعنى ألا يمثلوا بأحد وبلا تعذيب، حيث قال الله تعالى: {الشَّهْرُ
الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ } (سورة البقرة الآية 194) وهذا فيمن يقاتلون المسلمين، أما الذين لا يقاتلون من غير المسلمين فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتالهم: فعن
أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "انطلقوا باسم
الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً
ولا امرأة .." أبو داود، ج3 ص86 رقم 2614 وفي حديث آخر: "سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً" سنن ابن ماجة، ج2 ص953 كما كان ينهى عليه الصلاة والسلام عن التعرض للرهبان وأصحاب الصوامع، وعن التمثيل والغلول،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
بعث جيوشه قال: "اخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا
تعتدوا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع" مسند احمد، ج1 ص200
موقف الإسلام من غير المسلمين في حال السلم:
يقف
الإسلام من غير المسلمين في حال السلم موقف الأمان، بل إنه لم ينه عن البر
بهم ماداموا لم يقاتلوا المسلمين، وإنما ينهى عن البر بالذين قاتلوا
المسلمين في دينهم وأخرجوهم من ديارهم وظاهروا على إخراجهم، فقال جل شأنه: {لَا
يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ "8" إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ
اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن
دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن
يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "9"} (سورة الممتحنة
الآيتان: 8 ، 9) ونهى القرآن الكريم عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فقال الله سبحانه: {وَلَا
تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ
إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ } (سورة العنكبوت الآية 46) وقال سبحانه: {قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن
تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } (سورة آل عمران
الآية 64) بل أمر الإسلام بالوفاء بالعهد حتى مع المشركين، قال تعالى: {إِلاَّ
الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ
شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ
عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ } (سورة
التوبة الآية 4) بل لو طلب المشرك من المسلم أن يجيره فعليه أن يجيره، بل ويبلغه مأمنه، كما قال الحق تبارك وتعالى: {وَإِنْ
أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لاَّ يَعْلَمُونَ } (سورة التوبة الآية 6) ومن رعاية
الإسلام لحقوق غير المسلمين رعايته لمعابدهم وكنائسهم، ومن محافظته عليها
ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حان وقت الصلاة وهو في كنيسة
القيامة، فطلب البطريرك من عمر أن يصلي بها، وهم أن يفعل ثم اعتذر ووضح أنه
يخشى أن يصلي بالكنيسة فيأتي المسلمون بعد ذلك ويأخذونها من النصارى على
زعم أنها مسجد لهم، ويقولون: هنا صلى عمر. ولم تتوقف معاملة المسلمين لغير
المسلمين عند حد المحافظة على أموالهم وحقوقهم، بل حرص الإسلام عبر عصوره
على القيام بما يحتاجه أهل الكتاب وما يحتاج إليه الفقراء منهم. إن مثل هذه
المعاملة من المسلمين لغير المسلمين تطلع العالم أجمع على أن الإسلام ربى
أتباعه على التسامح، وعلى رعاية حقوق الناس، وعلى الرحمة بجميع البشر مهما
اختلفت عقائدهم وأجناسهم. وقد حفظت أجيال المسلمين قيمة هذه الرعاية
الإسلامية لحقوق غير المسلمين، لأنهم ما طبقوها إلا استجابة لتعاليم القرآن
الكريم، وتوجيهات الرسول العظيم عليه افضل الصلاة والسلام وقد طبقها في
حياته فوعاها المسلمون جيلاً فجيلاً، وطبقها الخلف عن السلف، والأبناء عن
الآباء، فهاهو ذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدث مجاهد قال: "كنت عند
عبد الله بن عمر، وغلام لم يسلخ شاة، فقال: يا عمر إذا سلخت فابدأ بجارنا
اليهودي، وقال ذلك مراراً، فقال له: كم تقول هذا؟ فقال إن رسول الله لم يزل
يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه".
المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في القضاء وسار المعاملات
أقام
الإسلام المساواة بين المسلمين وغير المسلمين في القضاء وفي سائر
المعاملات، وقد سجل التاريخ نماذج رائدة لهذه المعاملات التي تعتبر قمة ما
وصلت إليه المعاملات الإنسانية العادلة في تاريخ البشرية جمعاء. فعندما شكا
رجل من اليهود علي بن أبي طالب للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
عمر لعلي: قم يا أبا الحسن فاجلس بجوار خصمك، فقام علي وجلس بجواره ولكن
بدت على وجهه علامة التأثر، فبعد أن انتهى الفصل في القضية قال لعلي: أكرهت
يا علي أن نسوي بينك وبين خصمك في مجلس القضاء؟ قال: لا، ولكني تألمت لأنك
ناديتني بكنيتي فلم تسو بيننا، ففي الكنية تعظيم، فخشيت أن يظن اليهود أن
العدل ضاع بين المسلمين. وتتابعت وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل
الذمة والمعاهدين حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما" فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج12 ص259، ومعنى "لم يرح رائحة الجنة": لم يشمها. وقال عليه الصلاة والسلام: "ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة" سنن
أبي داود، ج3 ص437، سنن البهيقي، ج9 ص205 ومما يدل على المساواة بين
المسلمين وغيرهم في القضاء، وعلى انتشار الإسلام بسماحته وحسن معاملة
المسلمين لغير المسلمين: هذه الواقعة التي حدثت بين الإمام علي بن أبي طالب
كرم الله وجهه وبين رجل من أهل الكتاب، وذلك عندما فقد الإمام علي رضي
الله عنه درعه، ثم وجدها عند هذا الرجل الكتابي، فجاء به إلى القاضي شريح
قائلاً: إنها درعي ولم أبع ولم أهب، فسأل القاضي شريح الرجل الكتابي
قائلاً: (ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟). فقال الرجل: ما الدرع إلا
درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب، فالتفت القاضي شريح إلى الإمام علي
رضي الله عنه يسأله: يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب
شريح ما لي بينة، فقضى بالدرع للرجل، وأخذها ومشى، وأمير المؤمنين ينظر
إليه، إلا أن الرجل لم يخط خطوات حتى عاد يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام
أنبياء .. أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقضي عليه؟ أشهد أن لا إله إلا
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين؛
انبعث الجيش وأنت منطلق إلى صفين، فخرجت من بعيرك الأورق، فقال الإمام علي
رضي الله عنه: "أما إذ أسلمت فهي لك". وهكذا نرى كيف وصلت سماحة الإسلام
إلى هذا المدى الذي يقف فيه أمير المؤمنين نفسه أمام القاضي، مع رجل من أهل
الكتاب، ومع أن أمير المؤمنين على حق، فإن القاضي طالبه بالبينة، وهذا أمر
جعل أمير المؤمنين يضحك؛ لأنه على حق، وليس معه بينة، وواضح أنه المدعي،
والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، ثم تكون النهاية: أن يحكم القاضي
للرجل بالظاهر، حيث لم تظهر البينة .. إن هذه المعاملة السمحة، التي لا
يفرق فيها بين أمير وواحد من الرعية من أهل الكتاب جعلت الرجل يفكر في هذا
الدين ويتملكه الإعجاب بهذا الدين الذي يقف فيه أمير المؤمنين أمام قاضيه،
ويحكم قاضيه عليه لا له، بظاهر ما أمامه وإن كان ذلك خلاف الواقع، فأنطلق
الله الرجلان يقول: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء، وقال: أشهد أن لا
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويعترف ويقر بالحقيقة قائلا:
الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، انبعث الجيش، وأنت منطلق إلى صفين
فخرجت من بعيرك الأورق، ولكنه قد اعترف وأحب الإسلام ودخل فيه .. مما جعل
أمير المؤمنين يتنازل عن الدرع للرجل قائلاً: (أما إذ أسلمت فهي لك). إنها
صورة من صور القضاء في قمة عدالته، حيث يسوي بين هذا الرجل وبين أمير
المؤمنين، وصورة سماحة الإسلام في ذروتها حيث كان الحكم بالظاهر وعلى أمير
المؤمنين لا له، إن مثل هذه المعاملة السمحة مع غير المسلمين، هي التي قربت
الإسلام إلى الناس، وجعلتهم يدخلون في دين الله أفواجاً. أما صور التعصب
الممقوت التي يساء فيها إلى الإسلام فإنها لا تدفع الناس إلى الدخول فيه،
بل تدفعهم إلى النفور منه. ومن أجل هذا كان القرآن الكريم يجلي هذه
الحقيقة: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد
تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ
انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (سورة البقرة الآية 256) وأيضاً لا حرج فيه ولا مشقة: {وَجَاهِدُوا
فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ
الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ
الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ } (سورة الحج الآية 78) إنه دعوة إلى اليسر والتسامح لا إلى العسر والغلظة: {شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ
عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (سورة البقرة الآية 185) سماحة الإسلام مع غير المسلمين:
كما راعى الإسلام السماحة والمساواة بين المسلمين وغيرهم في القضاء، فإنه راعى السماحة في معاملة المسلمين لغيرهم: {لَا
يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (سورة الممتحنة الآية
بل قرر الإسلام حماية أهل الذمة والمستأمنين ماداموا في دار الإسلام، وهذا
الحق الذي قرره الإسلام لحمايتهم، يجب أن يعمل به أهل الأديان الأخرى في
معاملة الأقليات الإسلامية حماية لهم وتمكيناً لعبادتهم حتى يتم التعاون
بين عنصري الأمة، ولننظر كيف أكد الإسلام على حقوق أهل الكتاب والمعاهدين،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة"
سنن أبي داود، ج3 ص437، البهيقي، ج9 ص205 ومن وصايا سيدنا عمر بن الخطاب
رضي الله عنه "أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم" وإرساء لأسس
التعاون والتواصل بين عنصري الأمة أحل الله طعامهم فقال: {الْيَوْمَ
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ
حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (سورة
المائدة الآية 5) وشرع الزواج بالمرأة الكتابية، ولا رابطة في الظواهر الاجتماعية أقوى من ذلك، قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ } (سورة المائدة الآية 5)
وإذا كان التسامح وحسن المعاملة وعدم التعصب أموراً مطلوبة من المسلمين في
معاملتهم مع غير المسلمين، فإنها كذلك مطلوبة من غير المسلمين مع
المسلمين، حتى تتم معاملة كل طرف للآخر في دائرة التعاون والتضامن، فلا يسئ
أحدهم إلى الآخر، بل يتعاملون بروح الفريق الواحد في الوطن الواحد. وإن سر
انتشار الإسلام، واعتناق الناس له، ودخولهم في دين الله أفواجاً، هو
منهاجه الرباني، الذي أنزله رب العزة سبحانه وتعالى على رسوله صلوات الله
وسلامه عليه هذا المنهاج الذي أمر الله تعالى فيه بالدعوة بالحكمة،
والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. إنه منهج دعوة، وليس إكراهاً
ولا تشدداً ولا عنفاً، قال الله تعالى: {ادْعُ
إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن
ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } (سورة النحل الآية
125) وما أقر الإسلام العنف ولا التشدد: {لاَ
إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
(سورة البقرة الآية 256) وقال سبحانه لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون الذي ادعى الألوهية: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى } (سورة طه الآية 44)
وعندما خافا أن يبطش بهما بين الله تعالى أنه معهما يسمع ويرى ويؤيدهما في
دعوتهما، فالله سبحانه يؤيد كل داع يستجيب لمنهاجه، ويدعو بالقول اللين
الذي لا ينفر، فقال تعالى ردا عليهما: {قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى } (سورة طه الآية 46) وقاوم الإسلام العصبية، ودعا إلى التسامح، ففي الحديث: "ليس منا من دعا إلى عصبية"
ولم يقتصر تسامح الإسلام مع أهل الكتاب فحسب، بل إنه شمل حتى المشركين
فدعا الإسلام إلى منحهم الجوار والأمان حين يطلبه أحد المشركين، قال الله
تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ } (سورة التوبة
الآية 6) بل أن الإسلام يعتبر ضرب الإنسان الفاجر أو المعاهد دون ذنب أو بسبب جريمة يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من صاحبها فيقول: "ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لعهد ذي عهدها، فلست منه وليس مني"
مسلم (الإمارة) ص53 وذلك حتى لا يأخذ الناس بعضهم بعضاً بالظن، وحتى لا
تكون الحياة فوضى، فالإسلام لا يقر الظلم ولا العدوان، حتى على الفاجر أو
من كان معاهداً، فالفاجر فجوره على نفسه وحسابه على الله، ولسنا مطالبين
حياله إلا بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبمراتب مقاومة المنكر التي
أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" مسند
احمد، ج3 ص20، والنسائي، ج8 ص1011، الترمذي، رقم 2173 وليس لأحد كائناً من
كان أن يعطي نفسه الشرعية والحق في ضرب الناس، أو إكراههم باسم الإسلام،
فإنه بهذا التصرف يسئ إلى الإسلام وإلى سماحته.
عدالة الإسلام:
وقد
عني الإسلام برعاية أهل الكتاب، فقرر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
لهم كفالة في بيت مال المسلمين، فقد روي أنه مر بباب جماعة، فوجد سائلا
يسأل ـ وهو شيخ كبير ضرير ـ فسأله قائلاً: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال:
يهودي، فسأله: ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: اسأل الجزية، والحاجة، والسن،
فأخذ عمر بيده إلى منزله، وأعطاه، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال له:
انظر هذا وأضرابه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم!!
وما حدث في تاريخ سلفنا إهانة أحد من أهل الذمة، بل إن حدث أي تجاوز كان
يعالجه الإسلام في الحال، فعندما شكا إلى عمر أحد الأقباط ابن والي مصر:
عمرو بن العاص الذي لطم ابنه عندما غلبه ابن القبطي في السباق، وقال: أنا
ابن الأكرمين، أسرع عمر رضي الله عنه بإحضار والي مصر وابنه إلى مكة في
موسم الحج، وأعطى عمر الدرة لابن القبطي وأمره أن يقتص من ابن الأكرمين، ثم
قال لعمرو كلمته المأثورة: "متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم
أحراراً؟!". وقد أقام الإسلام العدل بين عنصري الأمة من المسلمين وغير
المسلمين، ومن رسالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قاضي القضاة أبي
موسى الأشعري قال له: (آس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك، حتى لا يطمع
شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك) فلا يصح التفرقة بين المتخاصمين حتى
ولو كان أحدهما غير مسلم. وهكذا نرى كيف عامل سلفنا أهل الكتاب، وكيف
أظهروا سماحة هذا الدين الذي لا يقر العصبية، ولا يرضى الظلم حتى لغير
المسلمين، بل يدعو إلى التسامح والعدل معهم. وهذا المنهاج المتسامح للإسلام
مع أهل الأديان الأخرى هو سر عظمة الإسلام، وسر ذيوعه وانتشاره في ربوع
المعمورة.
الإسلام دعوة كل الرسل
إن
الإسلام هو دعوة كل الرسل، ويتناول إطلاقه جميع الأديان التي أمر الله
تعالى رسله أن يبلغوها للناس، لأنه روحها الكلي، على اختلاف في بعض
التكاليف والأعمال، وينضوي الإنسان تحت راية الإسلام عندما تصح عقيدته،
وتخلص من كل شائبة من شوائب الشرك والنفاق، ويخلص في إيمانه وعمله لله
تعالى .. وهذا هو المراد بقوله تعالى: {وَمَن
يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي
الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (سورة آل عمران الآية 85) فالإسلام بمفهومه القرآني المشرق اسم للدين الإلهي الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل، وانتسب إليه أتباعهم جميعاً، يقول نوح لقومه: {فَإِن
تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى
اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ } (سورة يونس الآية
72) ويوصي يعقوب بنيه قائلاً، قال تعالى: {وَوَصَّى
بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللّهَ
اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ }
(سورة البقرة الآية 132) ويجيب أبناء يعقوب أباهم قائلين: {أَمْ
كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَكَ وَإِلَـهَ
آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَـهًا وَاحِدًا
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (سورة البقرة الآية 133) ويقول موسى عليه السلام لقومه: {وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ } (سورة يونس الآية 84) ويقول الحواريون لعيسى:
{فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى
اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ
وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} (سورة آل عمران الآية 52) ويقول بعض أهل الكتاب حين سمع القرآن: {وَإِذَا
يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ } (سورة القصص الآية 53) وقد وجه القرآن الكريم الأمة الإسلامية إلى بيان هذه الحقيقة في قوله تعالى: {شَرَعَ
لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ
أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ } (سورة الشورى الآية 13)
كما خاطب الله تعالى الرسل جميعاً مبيناً أن الإسلام والتوحيد قد أمر به
كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام وكافة الأمم، فالملة واحدة، متحدة في أصول
الشرائع لا تتبدل بتبدل العصور، قال تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ } (سورة المؤمنون الآية 52)
وتتخلص دعوة الملة القيمة في التوحيد الخالص لله الواحد الأحد: البعيد عن
العقائد الزائفة، مع اتباع جميع الأحكام المنوطة بأتباع الإسلام، كما قال
تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } (سورة البينة الآية
5) وقال تعالى: {قُولُواْ آمَنَّا
بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى
وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (سورة البقرة الآية 136)
فعلاقة الإسلام إذا بالأديان الأخرى علاقة الشيء بنفسه، مادام جوهره هو
جوهر كل الرسالات، ودعوة رسوله هي دعوة كل الرسل، وأما ما اختصت به العقيدة
الإسلامية الخاتمة من شرائع وأحكام فهذا مدلول معين على شريعة معينة،
وعلاقة الإسلام كشريعة للرسول صلوات الله وسلامه عليه بالأديان الأخرى تقوم
على أساس تصديق القرآن لما بين يديه من الكتب والهيمنة عليها.
وهذه العلاقة تأخذ اتجاهين واضحين:
الاتجاه الأول: علاقة الإسلام بالشرائع السماوية قبل تطورها وتغيرها.
والاتجاه الثاني:
علاقته بها بعد تطورها وتغيرها. أما الاتجاه الأول فالقرآن جاء مصدقاً لما
قبله من الكتب، وقد أخذ رب العزة سبحانه على كل نبي إذا جاء رسول مصدق لما
معه أن يؤمن به وينصره .. وتصديق الكتب المتأخرة للمتقدمة لا يعني أنها لا
تغير منها شيئاً، فهي مع أنها مصدقة لها إلا أنها تغير منها، كما حدث أن
جاء الإنجيل بتعديل أحكام التوراة، فأعلن عيسى عليه السلام أنه جاء ليحل
لبني إسرائيل بعض الذي حرم عليهم، وأيضا فقد جاء القرآن بتعديل بعض أحكام
الإنجيل والتوراة، إذ أعلن أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه جاء ليحل
للناس كل الطيبات، ويحرم عليهم كل الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي
كانت عليهم، وليس في هذا تناقض من اللاحق للسابق ولا إنكار منه له، وإنما
هو توافق وتناسب للزمن الذي تعيشه كل أمة، ليتواءم مع ظروفها وطبيعتها
وأطوارها المختلفة، فإن الذي يتناسب مع أمة من الأمم في طورها الأول قد لا
يتناسب معها في الطور الثاني، والذي يتناسب معها في الطورين الأولين قد لا
يتناسب معها في الطور الثالث، وهكذا .. نعم، هناك من الأمور ما تأذن
الشريعة اللاحقة بإبقائه واستمراره في نطاق ظروفه السابقة: كالوصايا العشر
مثلاً ما عدا الوصية العاشرة التي تحرم العمل يوم "السبت" فمثل ذلك من
التشريعات الخالدة التي لم تتغير بعد .. أما ما هنالك من تشريعات مؤقتة
بآجال طويلة أو قصيرة فهي تنتهي بانتهاء وقتها، وتأتي الشريعة اللاحقة بما
يوافق الأوضاع مصداقاً لقوله تعالى: {مَا نَنسَخْ
مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } (سورة البقرة الآية
106) إذاً ففي كل شريعة من الشرائع عنصران ضروريان للدعوة:
عنصر مستمر: يربط حاضرها بماضيها.
وآخر
غير مستمر: ويقوم بالتجديد بما يتناسب مع تطورها في كل زمان ومكان، فمثلاً
نرى شريعة التوراة تنص ضمن قوانين السلوك الأخلاقي على "النهي عن القتل
والسرقة .. الخ" ومن أهم ما تبرزه: طلب العدل والمساواة. ونرى شريعة
الإنجيل تقرر هذه المبادئ وتزيد عليها: "لا تراء الناس بفعل الخير" و"أحسن
إلى من أساء إليك" وأوضح ما فيها التسامح والإحسان .. فتأتي شريعة القرآن
فتقرر المبدأين معاً: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
} (سورة النحل الآية 90) {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ
عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ } (سورة الشورى الآية 40) وقال تعالى:
{وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن
صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ } (سورة النحل الآية 126)
وقد أضافت الشريعة الإسلامية كل مكارم الأخلاق، فلم تدع جانباً من جوانب
السلوك في التحية، والاستئذان، والمجالسة والمخاطبة، وما إلى ذلك من الآداب
السامية، والأخلاق الرفيعة كما هو موضح في سورة النور، والحجرات،
والمجادلة. إذاً فالشرائع كلها بمثابة اللبنات في بناء الدين، ومهمة اللبنة
الأخيرة: إكمال البناء وإمساكه، وبلوغه الكمال الخلقي كما قال عليه الصلاة
والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وقد وصف الله تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأكمل وصف، وأعظم خلق إذ يقول سبحانه وتعالى للرسول عليه الصلاة والسلام: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } (سورة القلم الآية 4) ويقول القرآن الكريم في بيان إكمال الدين، وإتمام النعمة الإلهية على العباد على يدي خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: {حُرِّمَتْ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ
لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ
بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن
دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ
فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (سورة المائدة الآية 3) ويوضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه موقفه من الأنبياء السابقين عليه كرسول خاتم فيقول: "إن
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع
لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه
اللبنة، قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين" رواه البخاري. صحيح
مسلم، والبخاري 4/151 طبع الشعب ج4 ص1790 وأما عن علاقة الإسلام بالأديان
السماوية الأخرى بعد تطويرها وتغييرها: فقد عرفنا أن القرآن الكريم جاء
"مصدقاً" لما بين يديه من الكتب و"مهيمناً" على تلك الكتب، والهيمنة تعني
الحراسة الأمينة عليها، والحماية الواعية لها من الدخيل الذي يدس فيها،
ويطرأ عليها، وإبراز ما تدعو إليه الحاجة من حقائق قد أخفيت منها، وتأييد
ما خلده التاريخ من حق وخير. وهكذا كانت مهمة القرآن الكريم .. فنفى وجود
الأمور الزائدة وتحدي ادعاء وجودها في الكتب: {كُلُّ
الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ
إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ
فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } (سورة آل
عمران الآية 93) وإبراز ما أخفوه: {يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا
كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم
مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ } (سورة المائدة الآية 15)
فعلاقة الإسلام إذاً بالأديان الأخرى ـ في طورها الأول ـ علاقة تأييد كلي،
وأما في طورها الأخير ـ المتطور ـ فهو تصديق لما بقى من أجزائها الأصلية،
وتصحيح لما طرأ من البدع والإضافات الغريبة عنها. وقد أمر الإسلام أتباعه
بالتعامل الحسن، حتى مع أبعد الأديان عنه، قال تعالى:
{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى
يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ } (سورة التوبة الآية 6) إن سماحة الإسلام
لتنفسح جوانبها، وتمتد ظلال الأمن فيها وارفة فتجير المشرك وتؤويه وتكفل له
الأمن، وتقدم له الرشد الناجع، والتوجيه السديد بالحكمة والموعظة الحسنة،
والمجادلة بالتي هي أحسن كما قال تعالى: {ادْعُ إِلِى
سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } (سورة النحل الآية 125)
بل وتكفل له الحماية والرعاية والأمان من كل غائلة .. كما ندب الإسلام
أتباعه أن يكون موقفهم من غير المسلمين موقف بر ورحمة وقسط وعدل: {لَا
يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ
وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } (سورة الممتحنة الآية وما أروع قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوم الحديبية: "والله لا تدعوني قريش إلى خطة توصل بها الأرحام، وتعظم فيها الحرمات إلا أعطيتهم إياها"
نماذج لأثر سماحة الإسلام
وأقدم
هنا بعض النماذج من سماحة الإسلام، وما كان لها من أثر كريم في نفوس الذين
عرفوها ولمسوها، حتى دخل بسببها في الإسلام أناس كثيرون. 1) إسلام ثمامة بن أثال: قال
الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال:
حدثني سعيد بن أبي سعيد: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي
صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة
بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: "ما عندك يا ثمامة؟" فقال: عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا
دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، فترك حتى
كان الغد ثم، قال له: "ما عندك يا ثمامة؟" قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم
على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد فقال: "ما عندك يا ثمامة؟" فقال: عندي ما
قلت لك، فقال: "أطلقوا ثمامة" فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم
دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا محمد
والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه
إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي،
والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن
خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم
وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله ولكن أسلمت
مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة
حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. وصحيح مسلم،
ج3 ص1386 وهذه القصة من أوضح الشواهد والدلائل على انتشار الإسلام بالحكمة
والموعظة الحسنة، وبروح التسامح والرحمة .. إنه انتشر بمبادئه الإنسانية
العالية لا كما يقول المتشدقون وأعداء الإسلام إنه انتشر بالسيف؛ كيف
والقرآن الكريم يقول: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ
قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ
انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (سورة البقرة الآية 256) ويقول سبحانه: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ } (سورة الكافرون الآية 6) ويقول سبحانه: {لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ} (سورة الغاشية الآية 22)
وهاهو سيد بني حنيفة "ثمامة بن أثال" قد أسره المسلمون في إحدى السرايا
دون أن يعرفوه، ولما جئ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه أكرمه
وأبقاه عنده ثلاثة أيام، وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام ويسأله قائلا:
ماذا عندك؟ فيجيب الرجل قائلاً: إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على
شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. ومعنى "تقتل ذا دم" أي صاحب دم،
لدمه موقع يشتفي قاتله بقتله، ويدرك ثأره لرياسته وعظمته. وفي رواية ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك"
وقد كان لهذه السماحة أثرها في قلب ثمامة جعلته يبادر بالدخول في الإسلام،
وقد سر الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامه كثيراً لما ترتب على إسلامه من
دخول قومه في الإسلام، ولم يقف الحال عند هذا، بل كان لإسلامه أثر هام،
فعندما ذهب إلى مكة للعمرة وهم أهلها أن يقتلوه، وفي رواية ابن هشام قال:
بلغني أنه خرج معتمراً، حتى إذا كان ببطن مكة لبى، فكان أول من دخل مكة
يلبي فأخذته قريش فقال: لقد اجترأت علينا، وأرادوا قتله، فقال قائل منهم:
دعوه فإنكم تحتاجون إلى الطعام من اليمامة، فتركوه. وزاد ابن هشام: ثم خرج
إلى اليمامة، فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً، فكتبوا إلى النبي صلى الله
عليه وسلم: "إنك تأمر بصلة الرحم، فكتب إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل
إليهم". وهكذا كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن يخلي بينهم
وبين حبوب اليمامة، ففعل ثمامة ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو
أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقهر القوم، وأن يلجئهم إلى الإسلام
مستعملاً القسوة، وانتهاز حاجتهم وضرورتهم لفعل، ولكنه لا يقهر أحداً ولا
يستعمل القوة، ولا يكره الناس على الدخول في الإسلام. وبعد أن انتقل الرسول
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكانت حركة الردة، وارتد بعض أهل
اليمامة، ظل ثمامة هذا ثابتاً هو وأتباعه، وراح يحذر المرتدين من أتباع
مسيلمة الكذاب قائلاً لهم: إياكم وأمراً مظلماً لا نور فيه، وإنه لشقاء
كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به منكم، ولما
لم يجد النصح معهم خرج هو والذين معه وانضموا للعلاء بن الحضرمي مدداً له،
فكان هذا مما فت في عضد المرتدين وألحق بهم الهزيمة. وهذا الموقف من رسول
الله صلى الله عليه وسلم مع ثمامة نموذج من نماذج التسامح العالية التي كان
الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل بها مع الناس، فقد كانت معاملاته عبر
حياته كلها تتسم بروح التسامح والرأفة، والدعوة إلى الإسلام بالحكمة
والموعظة الحسنة لا بالقوة والسيف. و
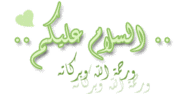
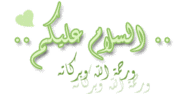

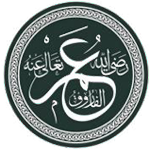

 الانتساب :
الانتساب :  العمر :
العمر :  المساهمات :
المساهمات :  نقاط التميز
نقاط التميز
